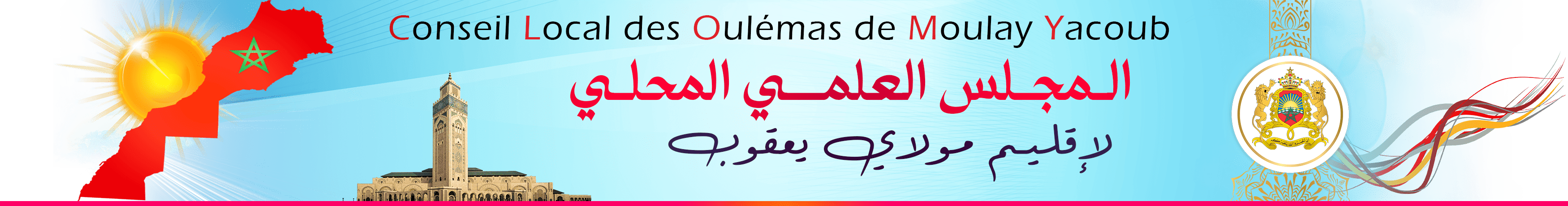من مقاصد العمل التضامني
للدكتور حسن عزوزي
لقد تميزت الشريعة الإسلامية بكونها ناظمة لجميع تصرفات الإنسان وأفعاله هادفة من ذلك إلى إسعاده في الدنيا والآخرة ، فقد اهتمت بتهذيب نفس الإنسان وتنقية وجدانه من صفات الشح والبخل والأنانية ودفعت به إلى ترقية سلم البذل والعطاء والإيثار والتضامن مع الآخر . ولذلك نظر الإسلام إلى الأمة على أنها أمة خيرة متضامنة تتقوى بانتظام أفرادها فيما يخدم مصالحهم ومنافعهم وتتأثر بأدنى خلل وظيفي من بعض أفرادها، من هنا يأتي حديث القرآن الكريم عن الأمة الإسلامية مرتبطا في معظم السياقات بإبراز وظيفة اجتماعية إنسانية محددة تلزم بأدائها في إطار من المسؤولية الأخلاقية المشتركة الهادفة إلى بناء المجتمع التضامني.
من الواضح أن الإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية والتغلغل في أعماقها من أجل غرس تعاليمه في جوهرها حتى تستحيل جزءا منها ، فإصلاح النفس يعتبر الدعامة الأولى لتغليب النزعة التضامنية في هذه الحياة وهو في ذلك ينظر إليها من ناحيتين:
إن فيها فطرة طيبة تهفو إلى الخير وتسر بإدراكه وتأسى للشر وتحزن لارتكابه.
إن فيها – إلى جوار ذلك- نزعات طائشة تبتعد بها عن سواء السبيل وتزين لها فعل ما يعود عليها بالضرر.
وهذه وتلك موجودتان في كل نفس إنسانية تتنازعان أمر الإنسان ويبقى مصيره معلقا بالجهة التي يستسلم لها قال تعالى ( ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها). لذلك فتهذيب النفس وإصلاحها تؤدي فيها التربية على القيم الأخلاقية دورا كبيرا في تنظيم التفاعل الاجتماعي وتوجيهه ، إذ هي التي تتولى ضبط سلوكيات الأفراد داخل المجتمع بحيث يساعد تماسك القيم على خلق حالة من التماسك الاجتماعي ، وإذا كانت القيم عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل العليا التي يؤمن بها الناس ويتفقون عليها فيما بينهم ويتخذون منها ميزانا يزنون به أعمالهم ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنوية ،فإن قيم التضامن تعتبر من أسمى القيم الإنسانية التي تقوم على التعاون والتآزر والتكافل وتعبر عن تربية جماعية تفاعلية لها ارتباط قوي بالتربية على حقوق الإنسان والتربية على المواطنة وغيرهما . فالتضامن سلوك يعبر عن وعي الناس فرادى وجماعات بالمسؤولية المشتركة الرامية إلى تحقيق المصالح والمنافع التي تجمع بينهم وتسهم في توثيق عرى التعاون والتآلف والتآزر بين الناس سواء في إطار الأسرة أو الجماعة أو الوطن أو في إطار العلاقات الإنسانية العامة.
وهذه القيم التضامنية قد تتخذ صورة لها وجهان :
أحدهما يرتبط بالكينونة الاجتماعية التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وقوله عز من قائل ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) حيث إن الإنسان ليس بإمكانه أن يوفر بمفرده ولنفسه كل ما يحتاج إليه من أمن وطعام .
أما الوجه الثاني فهو تطوعي اختياري يتخذ صبغة إنسانية عند انتشار الفقر والحاجة وأثناء وقوع الكوارث والآفات، وهنا يظهر التضامن في شكله الوجداني.
وهذا الوجه الثاني جانب عظيم في دستور الأخلاق الاعتنائية التي يدعو إليها القرآن الكريم ويسميها الإحسان تارة والبر تارة أخرى وينادي بها كل ذي ضمير إنساني حي فهي تشجع على بناء المصلحة العامة المشتركة من حيث التعاون والتآزر و التراحم ،وهذا من الأساسيات التي من دونها لا يمكن للمجتمع الصالح أن يحقق مستقبلا أخويا تسوده أخلاق التكافل والتضامن والمواساة.
وقد كانت قيم التضامن معروفة في ثقافتنا العربية الإسلامية قبل الإسلام إذ هي من مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها ، ويعتبر حلف الفضول واحدا من أهم وثائق حقوق الإنسان القائمة على قيمة التضامن والتآزر. وقد سمي الحلف بذلك لأن قوما من العرب تحالفوا على أن يردوا الفضول على أهلها وألا يغزو ظالم مظلوما ، ولذلك تحالف زعماؤهم وتضامنوا على أن لا يجدوا مظلوما إلا قاموا معه حتى ترد مظلمته. ويروي ابن هشام في سيرته(1/133. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت”.
ولما جاء الإسلام دعا إلى تعزيز وترسيخ قيم التضامن من خلال إيجاد قوام هيكلي من التعاليم الدينية السمحة التي ترغب في تمثل قيم التضامن والتكافل وتدعو إلى المسارعة إلى فعل الخيرات وكل ما يدفع إلى بناء المجتمع الخيري الذي يرتقي بأفراده ويجعل منهم نفوسا كريمة ومعطاءة تجاه مجتمعها تسارع إلى فعل الخير وإسداء العون وصنع المعروف وتسعى لنشر الألفة والمحبة والوئام والتعاطف والتراحم وغير ذلك من القيم التي يضمها ذلك الوعاء الرحب وعاء التضامن.
وهذه القيم التي لا يمكن أن يتصف بها إلا من تحلى بشخصية مفعمة بالإنسانية وحب الخير ومعقودة بالحس الاجتماعي النبيل ينظر إليها باعتبارها محددات للسلوك الايجابي ومعايير اجتماعية تترجم غالبا إلى قوانين منظمة أو أعراف أو تقاليد مشتركة على نحو يضمن استمرار الحياة وفق نوع من التوازن الوظيفي والانسجام العضوي ، ولذلك فإن الإنسان الذي ينطلق في تضامنه مع الاخر من إطار قيمي سليم يستطيع توجيه كل طاقاته وإمكاناته لخدمة مجتمعه.
إن القرآن الكريم وهو يتحدث عن قيم التضامن والبر والإحسان والتعاون يضعها في إطار من القداسة ويعتبرها الطاقة الكبرى لبناء المجتمع الخيري وترقية الإنسان وضبط حركته مع الناس ، مما يدل على أهمية التبصير بها والتوعية بفضائلها لأنها تتعلق بواقع الحياة اليومية التي تجمع الإنسان بأخيه الإنسان. وبالرغم مما تشهده منظومة القيم العالمية من تحول وتغير حتى أضحى كثير من علماء الأخلاق اليوم يتحدثون عن تحول القيم في صرخة محذرة من انفراط عقد القيم الأخلاقية، فإن مركزية العامل الديني في مجتمعنا الإسلامي يعطي لقيم التضامن واستمرار أثرها في النفوس قوة وثباتا، ولذلك نجدها تستمد روحها وقوتها من مجموعة من الدعائم والأسس لعل أبرزها دعامة الأخوة. إذ في إطار الأخوة يعيش الناس في المجتمع متحابين متضامنين يوحد بينهم شعور أبناء الأسرة الواحدة التي يشد بعضها أزر بعض وتسود بينهم إنسانية نبيلة تقرب بين الأفراد وتربط بينهم بمشاعر وعواطف تشعر كل واحد فيهم أن قوة أخيه قوة له وأن ضعفه ضعف له. فالإسلام يعلن الأخوة مبدأ وينادي بها فريضة ترتقي إلى درجة العقيدة والإيمان قال تعالى ” إنما المومنون إخوة”(الحجرات:10). ونعمة الإخاء الإسلامي هذه من أكبر النعم التي أنعم الله بها على عباده .قال تعالى ” واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا” ومن ثم كانت نعمة الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة، إذ لا تتعلق بنعمة التجانس الروحي فحسب وإنما تتعلق أيضا بما يقوم عليه كيان هذه الأخوة من تضامن وتكافل تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة وتتضاعف بهما مشاعر الإيثار ، الإيثار المنطلق في يسر والمندفع في حرارة.
إذ لا يمكن أن يتحقق التمثل الكامل لقيم التضامن ما لم يستند ذلك إلى تحرر وجداني وشعور نفسي باطن بأهمية هذه القيم وضرورة تفعيلها ،وبحاجة الجماعة إليها في اعتقاد راسخ بأنها تترجم غاية إنسانية نبيلة عليا ، ولن يستحق الإنسان ذلك بالتشريع قبل أن يستحقها بالشعور الوجداني وبالقدرة العملية على استدامة هذا الشعور ، فالمحافظة على التشريع أو النص الموجه لا تتم بصورة تامة إلا إذا كان هناك شعور وجداني يؤيده من الداخل ووازع عملي يؤيده من الخارج . إن الإسلام عندما دعا إلى بناء المجتمع التضامني من خلال تفعيل قيم التضامن ارتفع بذلك عن أن يكون محدودا أو أن يكون التشريع وحده هو الذي يكفلها ،بل أقام ذلك على ركنين قويين وهما: الضمير البشري من داخل النفس والتشريع المرغب في محيط المجتمع ،وزاوج بين هذه القوة وتلك مثيرا في الوجدان الإنساني أعمق انفعالاته، لكن من غير أن يغفل عن حقيقة ضعف الإنسان وحاجته إلى الوازع الخارجي ، ولذلك قال عثمان بن عفان (ض) قولته الشهيرة : ” إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن “. إن المتأمل في كل هذا يدرك مدى الجهد الذي وجهه الإسلام لتهذيب النفس الإنسانية من جميع جوانبها وجعلها ترنو إلى تحقيق خير الجماعة ورفاهيتها ، وتوسل الإسلام إلى ذلك بوسائل تربوية ناجعة من شأنها معالجة مبدأ التضامن في عمقه النفسي بما يخلق الاستعداد القلبي ويشحذ الضمير وينمي الشعور الوجداني. ونجد المعجم القرآني يستعمل مفهوم ” القلب” للتعبير عن موقع الحس الأخلاقي الذي ينفعل ويحس بفضائل القيم ومحاسن الأخلاق كما يحس برذائل الأخلاق ومساوئ السلوك فيميز بينهما، فيكون بهذا مرادفا للفظ ” الضمير” في الفكر الأخلاقي الغربي .
فصلاح النفس وتهذيبها في المنظور الإسلامي يعتبر الدعامة الأولى في مجال الحث على تعزيز قيم التضامن بين الناس. وتأتي التوجيهات القرآنية والنبوية في هذا المجال مشرعة لمبادئ ومثل ينبغي تمثلها والعمل بها ، فالتشريع الذي يرغب في سلوك سبل الخير والتعاون والتراحم يحتل مساحة كبرى في نصوص القرآن والسنة، وهي جميعها ترتكز على مدلولات من أبرزها التنوع والثبات وقوة الحافز والمسؤولية ، وتضع هذه النصوص منظومة قيم التضامن في إطار خاص من الاعتبار وتعتبرها الطاقة الكبرى لنشر الرحمة والألفة والتعاون بين الناس .
وهكذا فالأساس التشريعي القائم عل جهاز من الأحكام الشرعية الدافعة للمسلم إلى التشبع بقيم التضامن وتمثلها يبرز أمامنا في صورة عبادة مالية قائمة على أركان ومقومات تخدم بناء المجتمع الخيري بالبذل وإنفاق المال ولا يمكن أن يفهم الأمر على أنه مجرد مواعظ وآداب وأخلاق.
من جهة أخرى يتعين في هذا الاطار مبدأ المسؤولية الاجتماعية وهي مسؤولية ناتجة عن الإحساس بالشعور الوجداني والالتزام بالتشريع الموجه ، فالإسلام لم يكتف بالمفاهيم المستفادة من الأسس السابقة لكي يتم تحققها معنى وروحا بل يدعو إلى ترجمتها حقيقة وصورة من خلال العمل على ترسيخ البعد الإنساني والشعور بانتماء الفرد إلى الأسرة والحث على تفعيل مختلف أشكال التضامن والتكافل انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية. وإذا كان الإسلام يمنح الإنسان حريته الفردية في أجمل صورها فإنه لا يتركها فوضى، فللمجتمع حسابه وللإنسانية اعتبارها ولمقاصد الشريعة قيمتها، ولذلك يقرر مبدأ المسؤولية والتبعة الجماعية التي تعني أن هناك تكافلا بين الفرد والجماعة وبين الجماعة والفرد يوجب على كل منهما تبعات ويرتب لكل منهما حقوقا . فالمجتمع التضامني كله جسد واحد ينتابه شعور واحد ويحس إحساسا واحدا، وما يصيب عضوا منه تشتكي له سائر الأعضاء وهي صورة جميلة أخاذة يرسمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول مؤكدا على مسؤولية الجميع في الحفاظ على سلامة وصحة هذا الجسد الواحد: ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى” ويصور القرآن الكريم – من جهته- قيمة الإيثار كوجه من وجوه تضامن الصحابة فيما بينهم صورة رقيقة في نفوس الأنصار الذين استوعبوا مبدأ المسؤولية الاجتماعية فاحتضنوا إخوانهم المهاجرين وآووهم وأشركوهم في أموالهم وبيوتهم في تضامن مثالي يعتبر في تفاصيله أقرب إلى الرؤى الحالمة من عالم الحقيقة .قال تعالى : ” والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون” .
وما لم يكن إحساس الإنسان بمسؤوليته عن أخلاقه وسلوكه قويا ومتزايدا فإنه يعجز عن تغيير ما بنفسه من نقص وأنانية ويذهل عن عيوبها ، ولذلك جاء في الحديث : ” إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه”